جداليات الوطنية
بركان الهويات الفرّعية
يحي مفتي
لماذا موضوع الإنتماء الإثنولوجي والمذهبي والمناطقي
يكتسب أهمية دون غيره في بلد يتبنى أيديولوجية دينية يفترض
أن تكون جامعة، ويتلبّس، ظاهراً، زيّاً وطنياً يستوعب
ويعلو على الإنتماءات الفرعية؟ مقالة واحدة عن الانتماء
كفيلة بجذب طيف عريض من القراء، وبجلب مئات التعليقات،
وكأن الموضوع يفتح جرحاً بل جراح التجارب المرّة على مستوى
العلاقات الاجتماعية والمواقف الأيديولوجية المتبادلة،
والأخطر على مستوى تجارب القهر السياسي الذي عانته الجماعات
على قاعدة الانتماء.
انبعاث الهويات الفرعية هو في أحد تمظهراته، تعبير
عن فشل نموذج الدولة في هذه البقعة، وفي الوقت نفسه دليل
على أن قمع الهويات التقليدية/الفرعية لناحية إحلال هوية
فرعية أخرى بديلة لن يؤول الى تقويضها، وإن نجح في فترات
ما في إخماد فورانها أو تأجيل ظهورها التام والمليء.
كل الخبايا المدسوسة في اللاوعي الفردي والجماعي تندلع
من فوهة جدل الهوية والإنتماء، في سياق تعبيرات مضطردة
عن أزمة الدولة، الكيان الجيوسياسي السعودي الذي، رغم
كل مزاعمه الوطنية، بقي أسير نزوعاته الخاصة، التقليدية،
الفرعية..أي ماقبل الدولة.
ليس (عدم تكافؤ النسب) سوى النتوء النافر من أزمة عميقة
الجذور، ترتدي حللاً ثقافية حيناً، وإحتماعية حيناً آخر،
وقانونية أحياناً كثيرة، وتعكس في نهاية المطاف أزمة الدولة
السعودية.
تميط جداليات الهوية الستار تدريجاً عن أزمة الدولة،
وتنبىء بسوء طالع يقترب من لحظة الإنفجار، لا يؤجّل وقوعه
سوى الظروف الخارجية أو التدابير الطارئة التي لا تقترب
من صميمه بحال.
الصدمة التي عبّرت عنها الكاتبة أمل زاهد في مقالتها
بعنوان (ليست من بنات الحمايل بل هي من طروش البحر!) المنشور
في صحيفة (الوطن) في 28 فبراير الماضي ليست سوى انتباهة
متأخرة على واقع قاربه كثير من الباحثين والضحايا على
السواء. ورغم أن زاهد تذكّر قارئها بأنها ليست الصدمة
الأولى التي تحدثها (تعليقات تنضح عصبية وعنصرية بغيضة)
فقد زاد عليها ما قرأت (العجب العجاب) من تعليقات عصبية
عقب نشر الصحيفة خبر لم شمل فاطمة العزاز بزوجها منصور
التيماني، الذي حظي بقدر كبير من التداول الشعبي العام
على صفحات الجرائد ومواقع الإنترنت فضلاً عن المجالس العامة.
تقول زاهد (والكارثة أن هذه التعليقات لا تغرد خارج السرب
معبرة عن رأي كاتبيها فقط، ولكنها تعبر عن ذهنية عامة
تعشعش فيها العصبية، ولم يتمكن حتى الدين من اجتثاثها
من مكامنها السحيقة في العقل الجمعي!)، لتخلص الى نتيجة
(فنحن بلا جدل مجتمع يقتات على العصبيات بأنواعها وأشكالها
المختلفة (قبلية، طائفية، مناطقية، عرقية، عائلية).. بينما
يتوارى الدين بشرعه ومبادئه، والمواطنة بقيمها، والدولة
المدنية بأنظمتها.. لتصبح العصبية هي الدين والوطن والولاء
والانتماء!).
لا يكف المشهد العام اليومي عن تقديم فيض من الأمثلة
على رسوخ الهويات الفرعية، ولم يكن الشيخ محمد النجيمي
في لحظة لاوعي حين قدّم نفسه في حفلة المحاجّة مع الإعلامية
الكويتية عائشة الرشيد على قناة (سكوب) الكويتية بكونه
من (أبناء الحمايل)، فقد أفشى ما يمكن وصفه بـ (الهوية
المركزية) التي تعلو حين توضع باقي الهويات على المحك..فحين
تتحلل باقي الروابط لا تبقى سوى (الحمولة) الحاضنة، والمأوى،
والملاذ الأخير.
وستبقى موضوعة الإنتماء حاضرة على الدوام طالما أن
مقاربات جادة لم تبدأ بعد، حيث تتكثّف الأحاديث حول نقطة
الولاء بوصفها شأناً سياسياً بدرجة أساسية مفصولاً عن
أبعاده الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. جدير بالذكر
هنا، أن البعد السياسي ليس مخفّضاً في الهوية خصوصاً في
النموذج السعودي، كون الهوية استغرفت المجال الحيوي للدولة،
الى حد نبذ الأبعاد الأخرى، لأن ثمة من أراد تخفيضها أو
بالأحرى محوها لحساب تظهير الجانب السياسي للهوية.
وطنيّات هالكة
قد تكون جريدة (الوطن) السعودية الأكثر اشتغالاً بموضوعة
الوطنية ومتعلّقاتها (الهوية الوطنية، الوحدة الوطنية،
الإنتماء..الولاء، الخ) بين باقي الصحف السعودية، ولربما
كان من بين أغراض صدورها تعميم ثقافة وطنية من هذا القبيل.
رزمة مقالات نشرتها الجريدة على مدى سنوات حول الوطنية
ومشتقاتها، في مسعى، كما يبدو لإرساء أسس وعي وطني عام.
وفيما بدا أن مناقشة هذا الموضوع ستبقى مفتوحة، طالما
لم تترجم نفسها على الأرض في هيئة رؤى ومسالك عامة، فإن
السؤال الأولي ـ أو إن شئت المدخل الشرطي لمقاربة الموضوع
ـ هو بحسب لغة الفقهاء تحرير محل النزاع، فغالباً ما يتم
طرح موضوع الوطنية ومتوالياتها من خلال تمثّلاتها الخارجية
أو المتصوّرة أو المطلوبة، الأمر الذي يقفل باب الجدل
من اللحظة الأولى التي يبدأ فيها تعريف أصل المطلب.
سنحاول هنا تقديم قراءة بانورامية لما نشرته (الوطن)
من بعض مقالات تندرج في سياق الوطنية ومواردها، بهدف تشخيص
جذر المشكلة قبل العودة الى نقطة بداية حقيقية ومنطقية
لمقاربة هذا الموضوع.
في مقالة يحي الأمير بعنوان (الأمة السعودية..وخصوم
الوحدة الوطنية) في 19 يناير الماضي ما يشي بالتباسات
جمّة حول الحقائق الواقعية والمفاهيم الوطنية المجرّدة
باعتبارها معيارية تعين على تشخيص الحالة القائمة واقتراح
الحلول المناسبة لها. يبدأ الأمير من المتخيّل أو الإفتراضي
(الأمة السعودية) ليعقد على أساسه نظام محكمة لممارسات
لا تنتمي الى ما ابتدأ به. ليس هناك من الباحثين في شؤون
الدولة السعودية من يقطع بأن الأخيرة أنتجت نموذج الأمة،
بل يكاد يكون التسالم متيناً على أن هذه الدولة مازالت
تفتقر الى شروط الدولة الوطنية، بالنظر الى التمايز في
الثقافة العربية بين الوطن والأمة، بالنظر الى درجة الإنسجام
بين الدولة والشعب ومستوى التمثيل الشعبي في الدولة من
جهة، وبالنظر الى التوافقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية
والتاريخية واللغوية بين المكوّنات السكّانية وعلاقتها
بالدولة.
إن أقصى ما تحقق منذ العام 1932 وحتى اليوم هو سلطة
في هيئة دولة، أي الإنجاز السياسي للسلطة، ولم يتولّد
الكيان عن تعاقد إجتماعي. ماجرى بعد إنجاز الدولة السلطوية
لم يغيّر من جوهرها، فقد بقيت كذلك حتى اليوم، بدليل أن
هذه الدولة حين لم تحقق الاجماع الوطني المطلوب، لم تستدركه
في مرحلة لاحقة عبر برنامج إدماج شعبي في الكيان الدولتي،
أي ترميم الشرعية المنقوصة للدولة السعودية من خلال استيعاب
كل المكوّنات الجديدة في جهازها البيروقراطي، أي تحقيق
أهم شروط الدولة الوطنية وهو التمثيل الشعبي. لم يتم ذلك
البته، بل ما جرى في مراحل لاحقة هو أن تمدّداً مضطرداً
قامت بها الفئة الغالبة في بقية المناطق، وبدا التفوق
النجدي في كل مناطق المملكة السعودية بارزاً، فلن تجد
أمير منطقة من خارج العائلة المالكة، ولا محافظاً أو أمين
عام، أو مدير جامعة، أو مدير شرطة، أو رئيس محكمة إلا
إن كان نجدياً. وما يثير الغرابة أن تجد غلبة نجدية في
مجالس بعض المناطق رغم أن كل مجلس يفترض فيه تمثيل منطقة
وسكّانها. بالنسبة لأفراد الفئة الغالبة، التي قد يكون
يحي الأمير وغيره، ينتمون إليها، لا تبدو ثمة مشكلة، وهذا
طبيعي، فالضحايا وحدهم من يشعرون بألم القهر والاضطهاد
والتمييز، بل من الطبيعي أن يضفي الغالبون أوصافاً على
الدولة قد تصل الى ما يعتقدونها حقائق، ويلقون باللائمة
على غيرهم الذين فرّطوا في جنب (الأمة السعودية)، وهدّدوا
(الوحدة الوطنية)، لمجرد أنهم جهروا بحيف وقع عليهم، وجور
أصابتهم شروره.
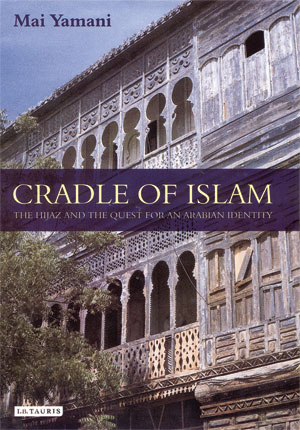 |
وحتى لا يبقى الجدل محصوراً في مجال التمثيل السياسي
للمكوّنات السكّانية، فإن الدولة لم تحقق أدنى الأدوار
في الإدماج الثقافي والاجتماعي والإقتصادي، بل ساهمت من
خلال تعزيز هويتها النجدّية بكل أبعادها في تعزيز الإنقسامات
الداخلية، وتفجير نزوعات الإنتماءات الفرعية. ولذلك، فإن
مقولة (وحدة السلطة في قسمة المجتمع) باتت واقعاً قائماً،
وتعبّر بشكل أمين عن رهانات السلطة السعودية.
يرى يحي الأمير بأن التشدّد هو المسؤول عن تسرّب الولاءات
والإنتماءات خارج (القيمة الوطنية العليا المرتبطة بالشكل
الحديث للدولة الوطنية). ولا شك أن رأياً كهذا يتجاوز
الحاجة لتشخيص دقيق لمشكلات متسلسلة: التشدّد، الإنتماء/الولاء،
الدولة الوطنية. فهل حقاً، أن التشدّد يفضي الى هذه النتيجة؟
ثم إذا كان كذلك، ماهي مصادر التشدّد، ولماذا التشدّد
في هذا البلد ينعكس تلقائياً على مسألة الإنتماء والولاء؟
هل يكفي أن نقول بأن التشدّد بطابعه الديني هو المسؤول
عن ذلك؟ أم هل للطابع السلفي المحلي دخالة في الأمر؟
الأدبيات السلفية تنطوي، دون ريب، على رؤية كونية وتنحو
لاعتناق مشروع (إصلاح الكون) كما تشي المواقف الإيمانية
من الآخر، كما تعبّر عنها بوضوح المصنّفات التيولوجية
الوهابية، وهي التي أرست الأساس الأيديولوجي لمشروع الدولة
السعودية، فما كانت الغزوات الغاشمة على المناطق المجاورة
تنطلق إلا على قاعدة أن أهلها مشركون وضالون ومبتدعة،
وتطوّرت الرؤية في مراحل لاحقة لتستوعب سكّان الأرض قاطبة.
لم تكن مسألة الولاء والانتماء مطروحة في أزمنة سابقة،
حين كان التشدّد السلفي مصوّباً ناحية الآخر، وليس الدولة،
بل كانت ويلات التشدّد تحظى بأشكال الدعم كافة من الدولة
والجمعيات الخيرية وعلماء الدين والمشايخ. وحينذاك أيضاً،
كان الخطاب دينياً، فالولاء لله ولرسوله وأولي الأمر،
فيما كان الولاء للوطن والدولة الوطنية رجساً من عمل الشيطان.
ولكن حين وجّه التشدّد الديني سهامه للداخل وللدولة الراعية
له، لم يعد هناك ما يبرر الركون الى خطاب ديني، يصعب احتكاره،
والتحاكم إليه خصوصاً حين يكون نقطة تصادم بين طرفين يتقاسمان
حق تمثيله، ولذلك عاد أهل الحكم إلى منطق الدولة، ولكن
لم ينعتقوا من نزوعهم الفئوي حتى وهم يتبنون هذا المنطق،
فقد أرادوه وطناً بشروطهم، كما أرادوا الدين بشروطهم أيضاً.
في هذا المناخ الموارب، تم طرح المفاهيم الوطنية، وصارت
مورد التنازع والتحاكم.
يجادل يحي الأمير بأن معيار التشدّد لم يكن وطنياً،
بمعنى أنه ليس قائماً على (الشراكة والمصلحة والإيمان
بالمستقبل انطلاقا من روح الحالة الوطنية القائمة أصلا
على الاختلاف والتنوع). حسناً، إنها معيارية مستجدّة في
بلد لم يألف هذا النوع من المفاهيم، لا على المستوى النظري
ولا على المستوى العملي. ومع ذلك، فإن الأدبيات السلفية
التي جرى تعميمها ونشرها بدعم من الدولة السعودية هي من
أرست معيارية فوق وطنية، وبإمكان القارىء للمصادر السلفية
الأولى بدءً من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن
عشر وصولاً إلى النشريات الشعبية التي راجت منذ نهاية
السبعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم أن يعثر على أدلة
مناقضة. المشاركات الفاعلة للتيار السلفي بشقيه المعارض
للسلطة والمتحالف معها عبر عمليات قتالية وانتحارية في
القارة الهندية، والعراق، واليمن، واليمن، وبلاد المغرب،
والبيانات الصادرة عن مشايخ سلفيين حول قضايا العالم،
والكتابات التي تنظّر لشؤون الخلق، والتصريحات الصادمة
التي يطلقها المشايخ على القنوات الفضائية لم تكن مبتكرات
جديدة، أو اجتهادات عفوية، بل لها ما يسندها في مناهج
التربية الدينية السلفية. لم يكن هؤلاء، والحال هذه، معنيين
بقضايا وطنية، شأن الدولة التي ينتمون إليها، وكانوا منشغلين
بهموم (الأمة) بحسب المفهوم السلفي، ولم تكن تعنيهم أيضاً
أوطان الآخرين، ولا سيادة الدول التي راحوا يبشّرون فيها،
باعتبار أن بلاد المسلمين تقع في المجال السيادي لرسالتهم.
هؤلاء الذين يطلقون الفتاوى التكفيرية ضد شخصيات ودول
ومؤسسات من خارج بلدهم لم يقفوا عند حدود أوطان الآخرين..
لم تكن فتاوى التكفير مهرّبة عبر الحدود، بل كانت تصدر
من أعلى سلطة دينية رسمية، كذلك بيانات التكفير الجماعي
التي مازالت تصدر من مشايخ مقرّبين من العائلة المالكة،
أو أحد أجنحتها.
ليس التشدّد السلفي هو وحده من جحد بالمفاهيم الوطنية،
ولا هو وحده من رفع سقف الانتماء، بل كانت سياسة رسمية
تبنّتها الدولة السعودية منذ نشأتها، ولم تتراجع عنها،
أو بصورة أدق لم تخفف وتيرتها إلا بعد كارثة الحادي عشر
من سبتمبر، حين وصفت الدولة السعودية بأنها (محور الشر)،
وتم تحميلها مسؤولية نشر خطاب الإرهاب في العالم.
هناك مايدعو للاختلاف أيضاً مع قسمة الكاتب الصحافي
الأمير لطرفين متخاصمين: الأول ينشد، حسب قوله، المصلحة
الوطنية العليا، باعتبارها مصلحة مرتبطة بثقافة الدولة
وكيانها، وإن تلبّست أبعاداً دينية واجتماعية، والثاني
يتجاوز الكيان الوطني لجهة الدفاع عما هو أكبر منه، وأنه
لن يكون سوى منصّة لنشر وترسيخ دعاواه الدينية. هذه القسمة
تبدو، في ظاهرها، صحيحة حين تنطلق من حقيقة واقعية، وهذا
يتطلب بادىء ذي بدء تعريف (المصلحة الوطنية العليا)، لأننا
أمام دعوى ملتبسة، ولربما نحن أمام غياب شبه تام لمثل
هذا المفهوم، فهل المصلحة الوطنية العليا مرتبطة بالشعب،
أم بالسلطة، أم بالكيان الجيوسياسي. وهناك من يحلو له
تقديم إجابة (تلطيفية) لإنهاء الجدل بأن يقول أن المصلحة
الوطنية العليا تعني ما ذكرت جميعاً، ولكن هل هناك تجسيد
للإجابة هذه على الأرض، أم أننا نزاول مراوغة خادعة للذات
وللآخر، وننأى عن اقتحام دائرة المحظور. ما يجده الفرد
العادي في هذا البلد عكس ذلك تماماً، ففي اللاوعي الجمعي
ثمة سلطة تقبع خلف مفهوم المصلحة الوطنية، وأن اختزال
الشعب والإقليم في سلطة الدولة تضع المصالح العليا في
دائرة السلطة القابضة على مفاصل الدولة.
يتناول يحيى الأمير مسألة أدلجة الدولة بقدر من التبسيط
والتعميم. يقول (على امتداد التاريخ الحديث الذي شهد ميلاد
الدولة القطرية الحديثة، لم يحدث أن نجحت أية تجربة وطنية
قائمة على أيديولوجيا). ورغم أن نزعة الأدلجة تسيطر على
كل دول العالم، وليست بالضرورة أن تكون الأيديولوجية متناقضة
مع مشروع الدولة، بل قد تكون هي ذاتها مشروع لإدارة دولة
مثل الدول الراسمالية والإشتراكية أو حتى الدينية، مالم
يكن القصد من الأدلجة المتناقضة مع مشروع الدولة، تلك
المشاريع التي تنادي بكيانات فوق قومية، مثل الشيوعية
والإسلامية. وعلى أية حال، لم تكن الأيديولوجية بصورة
عامة سبب فشل تجربة الدولة الوطنية، إلا إذا تحوّلت الأيديولوجيا
أداة لاحتكار السلطة، ومصادر إراداة الشعب والحريات العامة،
وتعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وعنصر المفاجئة في مقاربة الأمير يكمن في تطبيق تحفّظه
على أدلجة الدولة على التجربة السعودية (محلياً، يؤكد
التاريخ السعودي المعاصر إلى أي درجة كان الموحد العظيم
عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله مؤمنا بتلك الفكرة،
وكل الشواهد تشير إلى أنه اتجه إلى بناء دولة وطنية نهجها
هو الإسلام بصفته السلمية والإنسانية والتي تحث على البناء،
وثمة فرق كبير بين كيان وطني يجعل من الدين منهجا وبين
كيان آخر يجعل منه مشروعا، لأن اتخاذ الدين كمشروع وطني
يصطدم بالصفة الملازمة للدين وهي الأممية فالأديان للأمم
وليست لأوطان بعينها، ولكن حين يكون الدين منهجا، فإنه
يصبح عامل البناء الأبرز والأكثر قدرة على استيعاب التحولات
والمعطيات الوطنية). وسبب المفاجئة هنا أن يكون عبد العزيز
أقام دولة وطنية، بما يضعنا وجهاً لوجه أمام تراث ثقيل
من الأرشيف والوثائق والأدبيات الخاصة بتلك المرحلة والتي
كان عبد العزيز ينسج فيها كياناً يقوم على مدّعيات فئوية
(ملك الآباء والأجداد) إلى جانب مزاعم دينية: تكفير أهل
الحجاز (كما ذكر ذلك لجون فيلبي)، والغاء المحاكم القضائية
في الحجاز، وتكفير الشيعة في الأحساء والقطيف (كما ذكر
ذلك لأمين الريحاني)، واعتماد سفك الدماء وسيلة لإخضاع
المناطق في الشمال والجنوب، وكل ذلك كان يتمّ بإسم الإسلام
وعقيدة التوحيد التي شهرها في حروبه خارج نجد. فهل كان
الإسلام في رؤية عبد العزيز (نهجاً) أم (مشروعاً)؟ فهل
كان سفك الدماء، ومصادرة إرادة سكان المناطق الأخرى منهج
بناء؟ هل لمجرد إقامة كيان بعد استكمال مهمة الإلحاق القسري
يصبح الإسلام نهج بناء الدولة الوطنية؟ بل حتى أممية الإسلام
لم تكن في يوم ما عقيدة منبوذة لعبد العزيز، كما تكشف
وثائق تلك المرحلة، وقد حاول ضمّ مناطق عديدة في الجزيرة
العربية وصولاً الى فلسطين، وقد بكى عبد العزيز طويلاً
بعد مؤتمر العقير في كانون الأول من سنة 1922 حين قرّر
المندوب السامي وضع حدود دولة ابن سعود الشمالية خصوصاً
مع الكويت والعراق.
ينقل هـ .ر.ب. ديكسون في الجزء الأول من كتابه (الكويت
وجاراتها، ط1990، دار صحارى ص 280 ـ283) أن ابن سعود عمل
المستحيل لحمل المؤتمر على وضع حدود عشائرية بدل خط تحكيمي
يرسم على خارطة، على أساس تصنيف القبائل..وكان يرى من
الضروري أن تمتد حدوده الى الفرات. ولما أشار السير بيرسي
أن هذا الإدعاء غريب ولا يمكن أن يجري بحثه، تخلى ابن
سعود عن قبيلة ظافر.
ينقل ديكسون وقائع الجلسة التي جمعته مع بيرسي كوكس
وابن سعود (ففي اجتماع خاص ضم السير بيرسي وابن سعود وأنا
فقط، فقد السير بيرسي صبره واتهم ابن سعود بأنه تصرّف
تصرفاً صبيانياً في اقتراح فكرة الحدود العشائرية. ولم
يكن السير بيرسي يجيد اللغة العربية فقمت أنا بالترجمة.
ولقد أدهشني أن أرى سيد نجد يوبَّخ كتلميذ وقح من قبل
المندوب السامي لحكومة صاحب الجلالة الذي أبلغ ابن سعود
بلهجة قاطعة أنه سيخطط الحدود بنفسه بصرف النظر عن كل
اعتبار). ويصف ديكسون ردود فعل ابن سعود بالقول (..فانهار
ابن سعود وأخذ يتودّد ويتوسّل معلناً أن السير بيرسي هو
أبوه وأمه، وأنه هو الذي صنعه ورفعه من لا شيء الى المكانة
التي يحتلها، وأنه على استعداد لأن يتخلى عن نصف مملكته
بل كلها إذا أمر السير بيرسي بذلك).
 |
ويتذكّر ديكسون بأن ابن سعود لم يلعب دوراً يذكر في
المحادثات (تاركاً الأمر للسير بيرسي ليقرر حل مشكلة الحدود)
ثم يقول (وفي اجتماع عام للمؤتمر أخذ السير بيرسي قلماً
أحمر ورسم بعناية فائقة على خارطة للجزيرة العربية خطاً
للحدود من الخليج الفارسي الى جبل عنيزان بالقرب من حدود
شرق الأردن)، ويضيف (وإرضاء لإبن سعود حرم ـ أي السير
بيرسي ـ الكويت بدون شفقة من ثلثي أراضيها تقريباً وأعطاها
لنجد بحجة أن سلطة ابن صباح في الصحراء أصبحت أقل مما
كانت عليه يوم وضعت الإتفاقية الانكليزية ـ التركية).
يذكر ديكسون في وقت لاحقاً ما اعتبره (مقابلة مدهشة)،
ويقول (فقد طلب ابن سعود مواجهة السير بيرسي على حدة،
وصحبني السير بيرسي معه فوجدنا ابن سعود واقفاً وحده وسط
خيمة الاستقبال بادي الاضطراب.
وبادر ابن سعود السير بيرسي قائلاً بصوت كئيب:
ـ ياصديقي لقد حرمتني من نصف مملكتي. الأفضل أن تأخذها
كلها ودعني أذهب للمنفى.
وظل ذلك الرجل القوي العظيم واقفاَ رائعاً في حزن وانفجر
باكياً. وتأثر السير بيرسي كثيراً وأمسك بيد ابن سعود
وأخذ يبكي هو الآخر والدموع تنحدر على وجنتيه. ولم يكن
حاضراً تلك اللحظة سوى نحن الثلاثة) يؤكد ديكسون هنا (وأنا
أقصّ هنا ما شاهدته بكل أمانة). ثم يقول:
(ولم تدم تلك العاصفة العاطفية طويلاً فقال السير بيرسي
وهو لا يزال ممسكاً بيد إبن سعود:
يا صديقي إنني أعرف حقيقة شعورك، ولهذا السبب أعطيتك
ثلثي الكويت ولست أعرف كيف سيتلقى ابن صباح هذه الصدمة).
هذه هي باختصار قصة الدولة الوطنية التي أقامها ابن
سعود، والتي يغمرها الآن فيضان من الدعاوى الساذجة، فلم
يكن عبد العزيز مؤسساً لدولة وطنية، بل كان تلميذاً نجيباً
للسير بيرسي الذي تكفّل برسم حدود دولة ابن سعود (الوطنية!)،
التي كانت لولا السير بيرسي كوكس ترى النور.
وكما نرى في كل مجريات الترسيم أن عبد العزيز كان ينطلق
من كونه حاكماً نجدياً، ولذلك طلب من بيرسي كوكس أن يسمح
لقبائل نجد بالوصول الى العراق لشراء حاجياتهم، ولم يكن
يدرك معنى الوطن المتنوع القائم على التعدد. أما القول
(أن مشروعه كان مشروعا وحدويا ولم يكن مشروعاً انكفائياً
أو مذهبياً أو مناطقياً)، فذاك ما ينقصة فيض من الأدلة،
فقد كان وحدوياً في بعده السلطوي، ولكنه كان انكفائياً
ومذهبياً ومناطقياً في بعده الدولتي. هكذا تخبر الأيديولوجية
الدينية المشرعنة للدولة، وسياسات الاقصاء، وتركيز السلطة
في فئة محدودة حتى بات الجهاز البيروقراطي للدولة امتيازاً
نجدياً.
في المبدأ، صحيح أن التنوع والاختلاف لازمة من لوازم
الوطن، ولكن ليس هو الوطن السعودي الراهن، ولم يكن قط
القيمة العليا (في عملية التوحيد الكبرى التي أنشأها المؤسس..)،
فلم تكن غاية الوحدة وطنية، بل كانت سياسية وسلطوية محض.
الغريب هو ما يخلص إليه الكاتب الأمير بأن نموذج الدولة
السعودية هو (أقرب ما يكون إلى أمة سعودية)، كيف يكون
ذلك؟ يقول الأمير بأن هذه الأمة (تأخذ من قيم الدولة القطرية
الحديثة، وتعتمد الإسلام منهجا وتنحو إلى تخليصه مما علق
به من شوائب التقاليد والأعراف التي أنتجت نسخة دينية
باتت عائقا في طريق المشروع الوطني على المستوى الأمني
والتنموي المستقبلي). لا يبدو أن الأمير مدركٌ بصورة تامة
معنى الأمة، فضلاً عن أن تكون السعودية نموذجاً حقيقياً
للدولة القطرية الحديثة، أو نموذجاً للإسلام المعياري
الذي يراد له أن يكون ممثلاً للفئات السكانية في هذا البلد.
مثل هذه الأحكام المطلقة تستوجب مناقشة موسّعة، لتطبيق
معايير الدولة القطرية الحديثة، وكذلك الإسلام المعياري
(وهو نموذج افتراضي غير قابل للتطبيق في ظل تعددية المدارس
الفقهية والمذاهب)
إن ما يمكن وصفها بالتوصية التي أطلقها الكاتب يحيى
الأمير في ختام مقالته (إن صيانة مجد الملك عبدالعزيز
والتي هي مسؤوليتنا نحن المتنعمين بما حبانا الله به على
يديه من وحدة وكيان وطني تحتاج أولاً إلى التفريق بين
ما يمثل خطابا وطنيا وبين ما يمثل خلاف ذلك، وهي مسألة
واضحة وليست من المتشابهات)، ليست سوى قفزٍ على حقائق
تاريخية وسياسية، فلم يكن عبد العزيز يتبنى خطاباً وطنياً
في يوم ما، وكل ما كان يسعى إليه هو إقامة ملك عائلي على
أساس مدّعى شديد الخصوصية، سواء كان ملك الآباد والأجداد
أو المدّعيات الدينية الأخرى.
قراءة أخرى ذات طابع مدرسي قدّمها الشيخ أحمد بن باز،
نجل المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، في أكثر من
مقالة، الأولى نشرت في صحيفة (الوطن) بتاريخ 26 مارس الماضي
بعنوان (ثلاثية وطن..المواطن أولاً)، افتتحها بتعريف لغوي
للوطن، ومالبث أن حسم التباين بين مفهومي الوطن والدولة،
حيث اعتبر أن الوطن (مفهوم حديث للدولة)، بما يؤسس لإشكالية
مفهومية غير قابلة للحسم بسهولة، خصوصاً وأن الوطن والدولة
مفهومان مختلفان من حيث كون الوطن مفهوماً تاريخياً وثقافياً
وحضارياً فيما الدولة إطار جيوسياسي ودستوري.
الغاء الفاصلة بين المفهومين سهّل لدى الشيخ إبن باز
ـ الإبن الغرض الذي أقام من أجله مقالته، أي الكلام عن
ولاء المواطن للدولة ـ الوطن، وهنا تضيع المرجعية التي
يمكن التحاكم إليها، فهل هي الدولة أم الوطن، وهل يصدق
أي منهما على نموذج السعودية، وتالياً هل ثمة مفهوم للمواطنة
محدّد دستورياً ومجسّداً في سياسات الدولة، أو بالأحرى
في علاقات الحاكم بالمحكوم؟
وكما يظهر من سياق المقالة، وغيرها من المقالات الأخرى
لنفس الكاتب، فإن ثمة استهدافاً محدّداً يتغياه الشيخ
أحمد بن باز، فهو يتطلّع لترسيخ أسس الدولة ـ الوطن من
خلال تصعيد مشاعر الوطنية أي (أن تكون ـ الدولة ـ محاطة
من جميع أفرادها بمشاعر الوطنية، مسكونة بالوطن والولاء
لولاته حبا وعقيدة والانتماء لأرضه وسمائه فطرة وجبلّة).
ينشغل الشيخ ابن باز ـ الإبن بممحاكات جدلية ساذجة
حول الوطن، تحوم في فضاء لعبة المفاهيم، والتي عبّر عنها
في طائفة أسئلة طريفة: هل الوطن للرجال أم للنساء، للعقلاء
أم يشمل غير العقلاء، والتي تبدو أسئلة غير ذات صلة بحال
بمفهوم الوطن، فهذا الطراز من الجدل عقيم كونه يختزل المفهوم
ويقحمه في المهاترات الأيديولوجية الرثّة، أو تعود الى
جداليات القرن السادس عشر ومابعده حين بدأ طرح فكرة العقد
الاجتماعي.
في مقالته الثانية بعنوان (ثلاثية وطن..الوطنية) والتي
نشرت في صحيفة (الوطن) في 2 إبريل، لم يبرح الشيخ أحمد
بن باز الهدف الأولي، حيث أعاد تأكيد مفهوم الوطنية من
حيث كونها (تنمية وتفاعل مشاعر الحب والتعلّق والإنتماء
والولاء للوطن والدولة). وهذا الاقتطاع من مفهوم الوطنية
تهدف، كما هو واضح، إلى إرساء بنى وعي للدولة ـ الوطن
تغيب فيه الحقوق وتتثّب فيه الواجبات، بمعنى آخر، أن مفهوماً
كهذا يضع الواجبات على عاتق المواطن ويمنح الدولة كل حقوقها.
من اللافت في كتابات كثيرة نشرتها (الوطن)، أن الدولة
تظهر في هيئة (الضحية) و(المجني عليها)، فيما يظهر المواطن
وكأنه (الغاصب)، (المستأثر)، (الجاحد)، فيما كان المؤمّل
من الكتّاب الذين انبروا للكتابة في موضوع الوطن أن يكونوا
أكثر وعياً من سواهم فيما يرتبط بالاخفاقات التي أنجبت
اختلالات في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الحاكم
والمحكوم، وهي وحدها المدخل المنطقي والطبيعي لوعي مفهوم
الدولة الوطنية، ومتوالياتها. تبقى هناك استثناءات في
كتّابات الصحيفة، ونشير هنا الى مقالة علي سعد الموسى
(الوطن للجميع ولكن كيف) المنشورة في (الوطن) في 6 إبريل
الماضي والذي أضاء على مبدأ المساواة كشرط لاستزراع مفهوم
الوطن.
على أية حال، لسنا معنيين كثيراً بالموقف السلفي من
الوطن، وأن قول الشيخ ابن باز ـ الإبن بأن مصطلح الوطنية
(يواجه الكثير من الانتـقادات والاتهامات لدى مجمل الخطابات
الإسلامية) فيه تعميم وتجنٍ، وقد ينقصه العودة الى أدبيات
الجماعات الإسلامية غير بعض السلفية، والتي حسمت موقفها
من الوطن والوطنية منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
وعلى أية حال، فإن الوطنية المتعارضة مع الرابطة الدينية
أصبحت من الماضي، باستثناء بعض الجماعات السلفية المتشدّدة
في المملكة، والتي تمثّل أدبيات (القاعدة) أحد أهم منتوجاتها.
على أن من نافلة القول، أن المفتي السابق، والد الشيخ
أحمد كان هو الآخر ممن لا يؤمنون بالوطنية، ويرى بأن أمة
الإسلام هي الكيان الشرعي الوحيد، وأن الوطنية بدعة لا
يجوز الإيمان بها.
في استدراكه على مقالات الشيخ أحمد بن باز، كتب سعود
كابلي في (الوطن) نشر في 18 إبريل بعنوان (الحديث عن الوطنية:
تأسيس الهوية السعودية)، بدا أنه استشعر فراغاً في ما
طرحه بن باز الإبن فيما يرتبط بفكرة الوطنية وعلاقتها
بالهوية، وكذلك العلاقة بين الوطن والأمة باعتبارهما مفهومان
على علاقة وثيقة بالخطاب.
وزيادة في تفكيك مسألة الوطنية، يفرّق كابلي بين التعريف
اللغوي والتعريف الفكري، بحسب اختلاف الثقافات والتجارب،
منبّهاً الى أن (الوطنية) هي المكافىء الفكري لـ (القومية)
التي ظهرت في أوروبا في القرن الثامن عشر، وهذا صحيح تماماً.
ولذلك، فإن الوطنية ارتبطت بمفهوم (الولاء) للوطن في حين
القومية ارتبطت في الغرب بالهوية. وهنا يلفت كابلي الى
نقطة الاشتباك الجوهرية حيث يدور الحديث عن الوطنية بمعنى
الولاء لوطن (له حدود جغرافية واستقلال سياسي) والوطنية
بمعنى (الهوية) المؤسسة لوطن، بما يلغي التعارض بين الولاء
للوطن (الدولة) مع هوية المواطنين (الدين).
الوطنية، بحسب كابلي، حين تتأسس من منطلق الولاء تصبح
متصالحة مع الهويات المتقاطعة، ويسوي موقف الخطاب الاسلامي
مع الوطنية، حين لا تكون هوية (قومية مثلاً)، وإن بات
يتقبّل فكرة الولاء للدولة الحديثة.
مانقله كابلي عن مؤسسة (زوغبي الدولية) التي قامت باستطلاع
العام 2004 حول الهوية الرئيسية لدى مواطني أربع دول عربية
(السعودية، مصر، الأردن، لبنان) يشكّل مجسّاً واقعياً،
بالنظر الى تقارب إن لم يكن تطابق النتائج التي خلصت إليها
عمليات استطلاع أخرى جرت في نفس الفترة. حيث تبيّن أن
مواطني السعودية والأردن يرون بأن الإسلام هو المكوّن
الرئيس لهويتهم وليس مواطنتهم لدولتهم. وبحسب الاحصائيات
الصادرة عن المؤسسة فإن 56% من العينة يرون بأنهم مسلمون
في المقام الأول، فيما رأى 34% فقط بأن هويتهم الأساسية
هي سعودية ومن ثم مسلمين وعرباً.
القراءة في نتائج الاستطلاع التي يقدّمها كابلي تبدو
منطقية الى حد كبير، حيث تعكس النتائج الاشكال الذي (قد
يتأتى من أن نمضي في المناداة بالوطنية من حيث الولاء
للوطن في الوقت الذي لا يرى فيه الكثير أن هذا الوطن هو
مصدر هويتهم الأول). يثير كابلي هذه النقطة على قاعدة
التشابك الطبيعي بين الإنتماء (الهوية) والولاء، والتشديد
على ربط الوطن بالهوية، بحيث يصبح الانتماء للسعودية هو
انتماء جغرافي سياسي يعرّف الشخص نفسه من خلاله، أما حين
توضع الوطنية في سياق (ولاء لبقعة جغرافية) في حين يتم
تشكيل هوية أخرى مجاورة لها (فهو تجاوز لفكرة الوطنية).
السؤال المفصلي الغائب في مناقشة كابلي، هو لماذا لا
تزال الهوية مشكلة في هذا البلد، ولماذا يكون التلازم
بين الإنتماء والولاء؟ ولنعكس السؤال: لماذا عجزت الدولة
عن تصنيع هوية وطنية مولّدة لمشاعر وطنية جمعية تخّفض
أو تتصالح مع هويات أخرى، بحيث يصبح هناك تعايش بين هويات
متعدّدة وليست متعارضة، كما هو الحال في كثير من دول العالم،
حيث الفرد لا يجد تناقضاً بين أن يكون مسيحياً وفي الوقت
نفسه مواطناً في دولة حديثة، وقد يعبّر عن فخره بالإنتماء
لهويات أخرى فرعية عائلية وثقافية وأيديولوجية وحزبية.
ونجد ما نقله كابلي عن محمد المختار الشنقيطي بأن الفقه
السياسي الإسلامي مطبوع بانتمائه الى عالم الإمبراطوريات
وليس عالم الدول وأن العقد الاجتماعي الذي انبنت عليه
الإمبراطوريات الإسلامية المختلفة تأسس على (قانون الفتح
وأخوة العقيدة) هو ينطبق تماماً على السعودية، بل قد تمثّل
الوارث التاريخي للنموذج الإمبراطوري الاسلامي منذ سقوط
الخلافة العثمانية سنة 1924. فهي دولة تقوم على الاشتراك
في الدين والعرق القبلي.
انفجار الهويات الفرعية: القبلية
نموذجاً
رغم أن الهويات الفرعية (القبلية، المناطقية، المذهبية)
تعرّضت لمحاولات المحو قبل قيام الدولة السعودية وبعدها،
إلا أن السياسات الفاشلة التي رسمها مؤسس الدولة السعودية
الملك عبد العزيز بهدف تسييد هوية فرعية (قبلية، مناطقية،
مذهبية) على مجمل أرجاء الدولة أفضت الى نتائج عكسية تماماً،
وتظهر غالباً في ظل تقهقر قوة الدولة وانحسار هيبتها.
وفي ظل تغوّل العائلة المالكة في المجال العام، والذي
يعبّر عنه تسمية الشوارع، والمستشفيات، والمطارات، والجامعات،
والمدارس والمؤسسات الخيرية، والمسابقات، والجوائز الوطنية
والدولية، بأسماء الأمراء الكبار وزوجاتهم، أصبح هناك
ما يعبّر عنه بـ (انبعاث الهويات المقموعة). فقد لوحظ،
على سبيل المثال، إطلاق أسماء قبائل على المدارس والمساجد
في مناطق متفرّقة من المملكة. ففي الطائف على سبيل المثال،
لاحظ تربويون في شهر إبريل الماضي اشتعالاً متعاظماً بين
بعض القبائل لتسمية مرافق تعليمية ومساجد بأسماء قبائل
في الطائف، في سياق ما وصف بأنه (تأجيج النعرات والعصبية
القبلية) وطالبوا بإطلاق أسماء أعلام التاريخ الإسلامي
عليها. أما البعض الآخر، فرأى في ذلك ظاهرة صحية باعتبار
أن إطلاق أسماء القبائل على المرافق الخدمية والمساجد
يسهم في توثيق الإرتباط بين سكّان القرى، بل ذهبوا إلى
أن تسمية تلك المرافق يعتبر من أبسط حقوق أصحاب المكان
تقديراً للجهد الذي بذلوه للحصول على رخص البناء والتشييد.
يقول طالب في قرية بالطائف (إن عدداً من أقربائي المشبعين
بالعصبية القبلية عمدوا إلى بذل المساعي وإدخال المحسوبيات
واستجداء المسؤولين لإطلاق اسم القبيلة على مجمع تعليمي
تم تأسيسه في قريتنا أخيراً)، وقال بأن القبائل المجاورة
التي تقطن المنطقة امتعضت من هذه التصرفات، لا سيما وأنهم
يرون أنها تشعرهم بـ(الدونية) وتشعرهم بأنهم أقل شأناً
من غيرهم.
ويقول مدرّس في مدرسة ثانوية بأنه واجه خلال خبرته
في حقل التربية والتعليم كثيراً من الاشتباكات الطلابية
الدامية، تقف وراءها العصبية القبلية. ورأى مشرف تربوي
أن إطلاق إسم القبيلة على المنشأة التعليمية لم يأت لإرضائها
وكسب ودها، بل لتحديد موقعها الجغرافي، وأضاف بأنه كثيراً
ما يقرأ عبارات شوّهت المناظر الحضارية على أسوار المباني
تحمل في محتواها عصبية قبلية، مرجعاً وقوع الإشكالات خلف
إطلاق المسمى القبلي على المنشأة، إلى كيفية تعامل الأفراد
معه من واقع ثقافة المجتمع.
مدير الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في محافظة
الطائف سالم الزهراني ذكر بأنه توجد مدارس بنات عدة، تحمل
مسميات قبلية ضمن نطاق مهمات الإدارة، موضحاً أن إطلاق
تلك المسميات القبلية لا يقتصر على المنشآت التعليمية
في الطائف، بل يمتد إلى المدن والهجر في أنحاء السعودية.
واعتبر مشرف النشاط الثقافي بتعليم الطائف هلال الحارثي
تسمية بعض المعالم كالمدارس مثلاً باسم القرية أو المنطقة
التي أنشئت بها..يؤدي ذلك للعودة إلى عصر الاعتزاز بالعصبية
القبلية البائدة.. وأكد الخبير الأمني مدير شرطة جدة سابقاً
اللواء متقاعد مسفر الزحامي أن إطلاق المسمى القبلي على
المنشأة التعليمية له آثار سلبية من الناحية الأمنية،
معتبراً أن ذلك ترسيخ لمفهوم القبلية الذي يجب الهروب
منه وتوعية المجتمع بخطورته.
في المقابل، كان لعضو هيئة التدريس في جامعة الطائف
الدكتور سعيد الزهراني رأي مغاير عن سابقيه، إذ وصف تسمية
المدارس أو المساجد باسم القبيلة بـ (المنطق والمعقول)،
معتبراً ذلك من باب التوثيق للمكان حتى لا يصبح تاريخاً
ويندثر. ورأى أن إطلاق اسم القبيلة على أي مرفق خدمي ينمي
الارتباط في نفوس من يسكن القرية أو المكان، إلى جانب
تنمية الإهتمام بالمكان والحرص على نظافته ونموه. ملمحاً
إلى أن إطلاق الاسم من أبسط حقوق أصحاب المكان (تقديراً
للجهد الذي بذلوه من أجل الحصول على الموافقة لإنشاء المرافق
الحكومية التي تمثل المكان لا القبيلة).
من جهة ثانية، كتب أحمد عائل فقيهي مقالاً في (صحيفة
عكاظ) في 22 إبريل الماضي بعنوان (فضائيات الحزب..والمذهب
والقبيلة)، بدأه بحكم تعميمي بقوله (إن العالم العربي
والإسلامي يغرق في مياه آسنة ومتعفنة؛ اسمها المذهبية
والقبائلية والحزبية بصورة طاغية ولافتة)، ويرد ذلك إلى
ما أسماه (طغيان وصعود الفكر، الذي يرمي ويرمز ويهدف إلى
تأسيس كل ما يجعل الانتماء والولاء للقبيلة والمذهب والحزب،
أقوى وأكثر تقدما من الانتماء والولاء للدولة والوطن).
ويسلّط فقيهي ضوءا كثيفاً على دور الفضائيات بوصفها
أداة التواصل الأكثر تأثيراً وانتشاراً بما يطيح دور المؤسسات
العلمية والثقافية والأدبية، كما يظهر من صعود ذهنية الحزب
والمذهب والقبيلة (ليس في الحياة العامة وتجلياتها المختلفة،
وفي المشاهد الاجتماعية والاحتفالية التي نشاهدها كل يوم،
لكن انتقلت هذه المشاهد إلى الفضائيات، حيث نرى بزوغ وصعود
وظهور فكر الحزب والقبيلة والمذهب). يقول:(لقد أصبحنا
نرى قنوات فضائية بكاملها تروّج لهذا الحزب، ولهذا المذهب،
وهذه القبيلة، وكأن هذه القنوات الفضائية تحولت إلى دول
وفصائل تعمل كل واحدة منها وفقا لأجندة سياسية ومذهبية
ودينية وعشائرية دون أن نرى ما يعزز (فكرة الدولة) و(معنى
الوطن)، لا فكرة الحزب والمذهب، ومعنى القبيلة، وذلك من
أجل تحقيق المجتمع الحديث).
وفيما يحاول فقيهي استعارة نماذج من فضائيات غير سعودية
وبالتحديد عراقية، فإنه في الوقت نفسه يبعث إشارات ذات
مغزى محلي، كقوله (أن في بلادنا ظهرت ثقافة جديدة، هي
ثقافة العشيرة، والاحتماء بالإرث العشائري والعائلي، بل
هناك اليوم من تجده يعلق شجرة العائلة والقبيلة في وسط
وواجهة المجلس!! والأغرب أن هذه الظاهرة تنتشر بين طبقة
المتعلمين وذوي الشهادات العليا، بل إن هناك من يبحث له
عن جذور بين هذه القبيلة أو تلك العائلة، أو يذهب للتاريخ
القديم وللكتب والتاريخ بحثا عن (جذر) هنا، أو عرق هناك).
وفيما يرى فقيهي بان (إن انتشار فضائيات وقنوات الحزب
والمذهب والقبيلة، هي تعبير عن انتكاسة حضارية ونكوص اجتماعي
وهي ناتج للتفكير الذهني القاصر)، فإنه ينأى عن مناقشة
انتعاش الهويات الفرعية، من خلال وضع تصوّر واضح لجذورها
والأسباب الضالعة في نشوئها، أو انبعاثها في مرحلة زمنية
ما.
في تقديرنا، ليس ثمة ما يدعو للدهشة فالهويات الفرعية
تصارع من أجل البقاء حين تتعرض لخطر المحو، خصوصاً إذا
تم استعمال سلاح من سنخها أي القبلية في مقابل قبلية والمذهبية
في مقابل مذهبية وإقليمية في مقابل إقليمية. لم يكن مستغرباً
أن نقرأ كتاباً عن آل الرشيد وسيرتهم للبروفسورة الليبرالية
مضاوي الرشيد، وهي التي أكملت دراساتها العليا في جامعات
غربية علمانية/ليبرالية، ولا عن (مكة مهد الإسلام) من
منظور إنثروبولوجي للدكتورة مي يماني، وهي التي استوعبت
الثقافة الغربية الليبرالية، ولا (الشيعة في السعودية)
من منظور مذهبي وسياسي للدكتور فؤاد إبراهيم، وقد أكمال
دراساته العليا في جامعات بريطانيا، رغم خلفيته الدينية،
كما لم يكن مستغرباً صدور عشرات المؤلفات عن قبائل ومناطق
ومذاهب في أرجاء مختلفة من المملكة، بل أصبح هناك حتى
وقت قريب قنوات فضائية بأسماء مناطق..هل هؤلاء ضد الوطنية،
أو يحملون نزوعات انفصالية أو مناهضة لكل ماهو وطني؟
ما يحصل الآن، أن السباق المحموم بين الأمراء على وضع
أسمائهم وبصماتهم على كل شؤون الدولة قابله سباق مضاد،
وكل ذلك يجري في ظل متغيّرات جوهرية في ثقافة الناس ومواقفهم
من الدولة، فلم تعد الأخيرة بالمهابة ولا التي تخيف رعاياها
بأسلحة لم يعد بالإمكان التلويح بها، وليس استعمال الخطاب
الوطني بالذي يقدر على تهدئة بركان الهويات الفرعية، خصوصاً
حين يكون هذا الخطاب يحمل كل العناصر سوى أنه ليس وطنياً
البته.
|